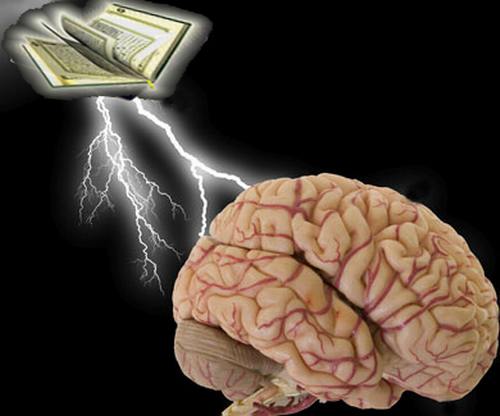بقلم د. أحمد خيري العمري
ديسمبر 2008
دشّنت إحدى وكالات الأنباء العالمية، أسبوعها الأول من بثها الفضائي باللغة العربية, ببرنامج طرح على الجمهور سؤالاً واحداً, لإجراء الاستفتاء والحوار عليه, والسؤال هو: أيهما أولاً الدين أم الوطن؟, وصيغة السؤال طبعاً تحكّمت بنوعية الأجوبة, وهذا هو ما يحدث مع نوعية الاستفتاء هذه، حيث يصاغ السؤال بطريقة تجعل المتلقي أمام مفترق طرق عليه أن يأخذ أحدها، وقد يختار طريقاً لمجرد أنه لا يريد الطريق الآخر -لكنه أيضاً لا يريد الطريق الذي اختاره فعلاً، لكنه يرفضه (أقل) فحسب!.
وقد تكون بنية السؤال نفسها تحتوي على إشكالية داخلية، كما لو أنها تُخير المتلقي، أو تجبره على المقارنة بين شيئين مختلفين تماماً، لا ينتميان إلى فصيلة واحدة، ولا توجد بينهما مقومات مشتركة للمقارنة, ورغم ذلك، فإن وسائل الإعلام بأذرعها الأخطبوطية تضع لمسة التسطيح إياها, وتجعل من المقارنة المستحيلة ممكنة، فقط من خلال طرح السؤال وجعله أمرا واقعا.
من هذا النمط من الأسئلة والمقارنات ذات الإشكاليات في بنيتها, ينتمي هذا السؤال: أيهما أولاً، الدين أم الوطن؟, لا نستطيع هنا أن نتهم تلك القناة الفضائية بافتعال الأمر من أجل إشعال الفتنة، فالسؤال المغلوط صار مطروحاً فعلاً، ولقد أبلى الكتاب الليبراليون بلاءً حسناً, في جعله موجوداً في مقالاتهم على صفحات الصحف, وعبر المداخلات على الشبكة.
وتمكّنوا فعلاً من جر (الإسلاميين) إلى خانة ضيقة, إما بجعل بعضهم يرد على السؤال بالطريقة التي يريدها الليبراليون بالضبط, (أي بأن يكون ردهم أن الدين يأتي أولاً، وهذا سيفتح باب مسألة ولائهم وإيمانهم, بمفاهيم الوطن والمواطنة.. إلخ), أو بجعلهم يزعمون أن لا مشكلة على الإطلاق في هذا الأمر, ويحاولون تأصيل مفهوم المواطنة في الإسلام بطريقة سطحية جدا, مثل استخدام أحاديث موضوعة من نوع “حب الوطن من الإيمان”!, والحقيقة أن الموقفين هما ما يتوقعهما المرء من أسئلة كهذه.
سأحاول أن أتجنب الجواب على سؤال افتراضي كهذا، مع الإشارة إلى إيماني أن مفهوم (المواطنة) فعلاً غير موجود بشكل واضح في الإسلام، لكني أؤمن أيضاً بعدم وجود تعارض حقيقي بينهما, لكن ليس هذا هو ما أريد أن أوضحه هنا على الإطلاق، بل أريد أن أتأمل في السؤال نفسه، في المفاضلة بين شيئين لا يمكن وضعهما أصلاً في مسألة واحدة.
أتأمل في مفهوم (الوطن) أولاً : أي “وطن” بالضبط يقصده من يدير النقاش هنا؟, ألم يكونوا قد بشرونا قبل سنين أن العولمة قد ألغت المفهوم التقليدي للوطن؟, وأن الدول في عصر العولمة هي دول بلا سيادة؟, بل ألم يطلق على هذا العصر اسم “عصر أفول السيادة”؟, ألم تلغ ثورة الاتصالات, وما نتج عنها الحدود التقليدية بين الدول؟, ألم يكن العالم كله قد تقلّص إلى قرية كونية صغيرة؟, فلماذا رجعنا -الآن- بالذات في سياق الخيار مع الدين (إلى المربع الأول لمفهوم الوطن), وبالشكل الحديدي الذي يعود للقرن الـ19؟, لماذا؟.
نغّير صيغة السؤال قليلاً، ونوجّهه إلى موظف في شركة من الشركات العابرة للقارات, بالضبط موظف في ذراع محلي من الأذرع الأخطبوطية لتلك الشركات التي تمتد في كل مكان, ماذا لو سألناه، أو سألنا مديره الأعلى على قمة (الفرع المحلي):
أيهما أولاً/ مصلحة “الشركة”، أم مصلحة “الوطن”؟, لا جدال أنهما سيردان أن لا تناقض هناك بين الأمرين، وأن تلك الشركات تقوم بتقليص البطالة وتشغل الشباب، لكن الحقيقة التي لا يمكن الجدال فيها أنها تجعلهم مجرد موظفين عند شركة كبرى, ومصلحتها أرباحها هي الأهم, ولو على حساب الاقتصاد المحلي والمنتج المحلي, وكل ما هو محلي, وبعض هذه الشركات العملاقة، التي ميزانيتها أكبر من ميزانيات بعض الدول الصغيرة، يمكنها أن تلتهم دولاً وأن تسقط أخرى في الديون، وحتى أن تشعل حروباً من أجل مصلحتها.
إذا أجاب أي موظف عن هذا السؤال -أنه سيقدم مصلحة بلده على مصلحة الشركة التي يعمل فيها- فإن هذا سيطعن في مهنيته فوراً, وبالتالي في أخلاقه المهنية، وهذا سيفتح باباً آخرَ من التساؤلات.
السؤال نفسه يمكن أن يطرح على الموظفين, ورؤساء الفروع في البنوك العملاقة ذات الفروع المتعددة, أيهما تفضل: -عند حصول تعارض ما- الفائدة الاقتصادية لبلدك, أو خسارة البنك الذي تعمل فيه، أم العكس، ربح البنك وخسارة بلدك؟, هل سنصدق أي جواب يفيد بأي شيء غير إثبات الولاء لهذا البنك وأرباحه؟.
لِمَ الأمر يكون مقبولاً عندما يكون جزءاً من أخلاقيات العولمة العابرة للقارات -أو على الأقل مسكوتاً عنه- ويصير إشكالياً ومنافياً للمواطنة عندما يكون مرتبطاً بالدين (وبالإسلام تحديداً؟).
ماذا لو أجبنا على أسئلتهم بأسئلة أخرى/ ماذا لو سألنا من يطرح هذه الأسئلة سؤالاً مقابلاً:
-أيهما أولاً: حريتك الشخصية أم الوطن؟.
-أيهما أولاً: مبدأ “الفردية” أم الوطن؟.
-أيهما أولاً: حرية التعبير عن الرأي أم الوطن؟.
سيقولون ويؤكدون أن الوطن يجب أن يضمن هذه (الأشياء) كلها، ولذا لا تعارض بينهما, ما الذي يجعل هذا هنا بديهة ولا يجعله مع قيم “الدين” مثلاً -أم أنهم يريدون “وطناً” على مقاس “قيمهم” فقط-, لماذا يكون هذا صواباً معهم، وليس صواباً مع الإسلاميين مثلا,ً الذين سيرون أيضاً أنه لا تعارض ما دام أن الوطن سيتركب على أساس الدين؟.
ومرة أخرى: لماذا يفترضون أن القيم الدينية إذا جاءت قبل الوطن سيكون ذلك نقصاً في المواطنة، ولكن ليس الأمر ذاته مع قيم أخرى مثل حرية الرأي والحرية الشخصية إلخ…
ألا يتنادى الليبراليون في كل مكان، إذا تعرضت قيمهم للحظر حتى لو كان ذلك في دول أخرى؟, ألا تكفي حادثة صغيرة (وربما فردية) ولكنها تنتهك قيمهم لتجييش مشاعرهم، وربما ما هو أكثر؟, ألم يستفزهم جميعاً وفي كل الدول -أن حكماً بالإعدام قد صدر على أفغاني قد ارتدَّ عن الإسلام؟, فهبوا جميعاً من أجل «الحرية الشخصية»- رغماً عن أنف الحدود والخرائط الدولية.
ألا يسيّرون المظاهرات ويقيمون المؤتمرات, يضغطون ويهددون بقطع المعونات وحتى العلاقات, من أجل مفهوم “الجندر” و “تمكين المرأة”.. إلخ.
لماذا قيمهم يحق لها أن تكون عابرة للقارات، وأن تكون قبل “المفهوم التقليدي” للوطن, ولكن لا يحق ذلك للقيم الدينية وللمؤمنين بها؟.
في السياق نفسه، وضمن الاستطلاع الفضائي ذاته، ُوجه سؤال إلى فتاة مصرية محجبة (جداً):
هل المسلم الباكستاني أقرب إليك من المصري القبطي؟.
الفتاة ردَّت بذكاء, لكن السؤال نفسه يستحق التوقف, فبعيداً عن اختيار المسلم (الباكستاني – الأفغاني) ودلالاته التحريضية، فإنه من التسطيح اختزال أي إنسان بهذا الشكل: مسلم باكستاني، أو قبطي مصري, قد يكون هذا المسلم الباكستاني مسلماً بالهوية فقط، وقد يكون لا يعرف من الإسلام ولا عن الإسلام شيئاً، وقد يكون على العكس من ذلك، مسلماً صالحاً عالماً (للذرة!), وشخصاً حاصلاً على أرقى الشهادات التي يحاول خدمة مجتمعه بها.
وقد يكون غير ذلك، وقد يكون بين ذلك وذلك، كما سيكون جارك المسلم أو حتى شقيقك, هل من الممكن -وهل من العدل أصلاً- اختزال أي إنسان إلى خانة واحدة في هويته فحسب؟.
– ثم ما هو مقياس (القرب والبعد) المقصود؟.
– وكيف يمكن لفتاة مصرية أن تكون (أقرب أو أبعد) لشخص لم تره في حياتها ويعيش في قارة أخرى؟.
– هل المقصود بالقرب هو محض التعاطف؟.
– هل هناك قانون يمنع التعاطف؟.
– وهل التعاطف مع آخر من دولة أخرى يناقض مفهوم المواطنة؟.
– هل يخشى من هذا التعاطف أن يتطور ليصير شيئاً آخر؟.
نعم… لقد حصل ذلك فعلاً، لكنه لم يحصل إلا بمباركة ودعم من الحكومات المعنية, (وهي الحكومات نفسها التي تحارب الآن مجرد فكرة التعاطف!).
إن مفهوم المواطنة في الإسلام يحتاج فعلاً إلى تأهيل وتأصيل، لكن استعداء الدين بهذه الطريقة لن يبني دولة ولا وطناً، فبوسع القيم الدينية عندما تستثمر إيجابياً، أن تشكل إنساناً منتجاً فاعلاً للمجتمع -ويمكن لها عندما تستعدى أن تتحول لتصير هدّامة فعلاً- والطريقة التي يتم بها طرح هذه الموضوعات حالياً استعدائية تماماً, ولن تخدم “الوطن ولا المواطنة”.