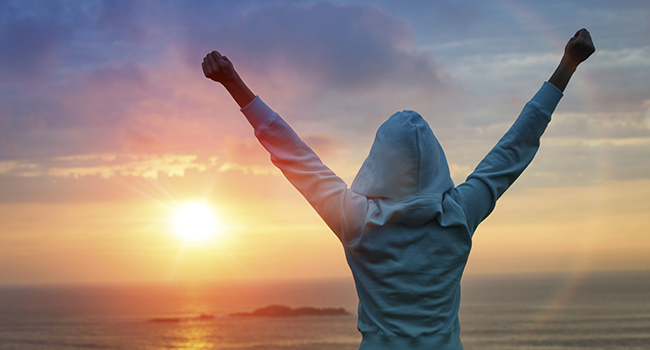أحمد خيري العمري 2008
تاريخ أية أمة هو جزء من تكوينها الأساسي، لا يمكن الهروب منه. إنه مثل تاريخ مولدك ومكانه، “قَدر” لا فرار منه. مهما حاولنا، ومهما حاولت أية أمة، فالفرار من التاريخ عبثٌ يظهر في طياته سيطرة هذا التاريخ، إلى درجة محاولة الفرار اليائسة تلك..
تاريخ أية أمة هو جزء من” شيفرتها الجينية “، التي قد لا تكون ظاهرة للعيان، لكنها تتحكم بكثير مما يظهر ومما لا يظهر للعيان، وهذه الشيفرة قد تحتوي على كثير من السلبيات كما تحتوي على كثير من الإيجابيات، آلية التعامل مع هذه المنظومة الوراثية، قد يقوي بعض ما هو سلبي فيها، وقد يحيد في الوقت نفسه الجواب الإيجابية فيها..
تاريخنا ليس استثناء من هذا، بل إنه ربما كان التاريخ الذي يتمثل فيه هذا أكثر من أي تاريخ آخر، ولأنه تاريخ التجربة الإسلامية الحافلة، فقد كان فيه كل شيء، وتجلت فيه إيجابية الإنسان وسموه وقوته، في عهد حضارته وازدهاره، كما ظهرت نقاط سلبيته وضعفه في عهد انحداره..(وهو تاريخ أفضل من تاريخ كثير من الأمم حتى في عهد انحداره) وهو أمر لا يمكن اعتباره إلا جزءاً من “طبيعة الأشياء“..
ليست المشكلة في تاريخنا بالتأكيد، لكنها في إصرار البعض على “التعامل المطلق” مع هذا التاريخ، ومن خلال لون واحد من اثنين: إما الأبيض، وإما الأسود.. مع الإصرار على تجاهل أن الحقيقة الإنسانية تشكل كل ألوان الطيف، وتسكن بالذات النماذج بين هذه الألوان، ونادراً ما تكون في لون مستقل عن الألوان الأخرى..
أصحاب اللون الأبيض يصرون على صبغ التاريخ بهذا اللون، لكنهم يدّعون أن هذا هو لونه الحقيقي، إنهم يعتبرون أن تاريخنا منزه عن الخطأ وعن الخطيئة، وتعاملهم مع ما يعتبر “خطأ” يتلخص في موقف من اثنين، إما إنكار وقوع هذا الخطأ أصلاً عبر اتهام “الأعداء” بالافتراء والكذب وانتحال الخبر كله، (حتى لو كان الخبر وارداً في مصادرنا، وليس مصادر الأعداء)، أو الموقف الثاني، الأكثر سوءاً وخطورة، وهو الاعتراف بوقوع “الخبر”، ولكن عدم اعتباره “خطأ”، أي محاولة تبريره عبر البحث عن “نص” ما، يمكن تأويله ومطه “ظلماً” ليمرر هذا الخطأ، أو عبر إدخاله من بوابة “الاجتهاد الخاطئ” الذي سيحصل أجراً واحداً بدلاً من أجرين..
الموقف الأول أنكر حصول بعض الأخطاء والمظالم في الفترة الانتقالية بين العصر الراشدي والعصر الأموي، على الرغم من وجود إشارات واضحة لهذا في كتب الصحاح. أما الموقف الثاني فلم ينكر حصول المظالم والأخطاء، لكنه حاول تبريرها وشرعنتها، وهذا لا يقل سوءاً، لأنه يعطي الشرعية لاستمرار هذه المظالم في عهود أخرى – وحالية أيضاً-ولو أن الأمر ترك بلا تبرير، أو فسر على أنه سياسة دولة، وطبيعة المرحلة.. إلخ، لكان أفضل، لأنه لم يكن ليرتبط بالدين، أو بفقه النص، أو بالفتوى المرتبطة بالنص..
أما الفئة الأخرى، من أصحاب اللون الأسود، فهم الجهة المعاكسة “النيجاتيف” من الفئة الأولى، إنهم يصرون على أن لا شيء في هذا التاريخ سوى المظالم والأخطاء، لا عدل هناك ولا حضارة ولا بناء على الإطلاق، ليس سوى تاريخ مستمر من الظلم و”المظلومية“. وهؤلاء ينقسمون بدورهم إلى قسمين:
قسم ينتمي إلى “أهل القبلة” ورؤيتهم هنا للتاريخ هي رؤية طائفة نتجت أصلاً عن بعض هذه الأخطاء والمظالم، ومع الوقت، تخندقت داخل رؤيتها الطائفية الضيقة، ولم تنجز تاريخاً أفضل في الوقت نفسه، كما لم تنحاز حقاً إلى قيم العدالة، لأنها كررت الأخطاء والمظالم نفسها، وربما بدرجات أكبر كلما سنحت لها “الفرصة التاريخية”، بالذات نجحت في تكرار الأخطاء، وفشلت في انجاز الايجابيات التي تحققت في التاريخ الذي تهاجمه.
القسم الثاني هو قسم لا ينتمي فعلياً إلى أهل القبلة، بل ينتمي إلى فئة بعض المستشرقين، وأتباعهم من المستغربين (وهم عموماً أسوأ من المستشرقين)، وهؤلاء عمدوا إلى اللون الأسود كعدسة لرؤية التاريخ من أجل نسف تجربة الإسلام ككل، واعتماداً على معطيات المظالم المتبادلة نفسها، والهدف من هذا النسف واضح: إنه إذا لم ينجح الإسلام في أي شيء وقتها، فإنه على الأغلب لن ينجح لاحقاً و في أي وقت آخر.
وعلى الرغم مما يبدو من اختلاف كبير بين موقف “التبييضيين” و”التسويديين”، إلا أن هناك ما هو مشترك بينهما، بل إن وجود كل منهما أساسي لوجود الآخر، فسدنة التبييض، الذين يحاولون تقديس التاريخ وتنزيهه رغم “أنف” التاريخ، يجدون تبريراً لما يفعلون عبر دفاعهم عن التاريخ وإيجابياته من هجمات زبانية التسويد، خصوصاً في مرحلة تخندق طائفي كالتي نمر بها، وهي هجمات تريد نسف كل شيء في التاريخ: الصالح والطالح منه، وهؤلاء الزبانية في الوقت نفسه، يعتمدون على مغالطات السدنة وتزويقهم الساذج وإنكارهم للحقائق، للترويج لرؤيتهم التسويدية.. ومع الموقفين، ليست الحقيقة “الموضوعية” وحدها الضحية، ولا “التجربة الإنسانية” التي لا تعرف الأبيض والأسود بهذه الحدة، ولكن أيضاً هناك “المتلقي” المحبط على مذبح التبييض والتسويد على حد سواء، إنه محبط مع التبييضيين لأن التاريخ المبيض لا يبدو بشرياً أبداً، لا يبدو أنه تاريخ من صنع البشر (الذين يشبهونه) بل هو من صنع الملائكة تقريباً، ما دام كان منزهاً عن الخطأ لهذه الدرجة.. وهذا محبط لأنه غير صالح للاقتداء، فالتجربة البشرية لا بد لها من أخطاء كي تكون بشرية، كي تكون “قدوة”، كي تكون قابلة للتصويب والتسديد. كما أن التاريخ المبيض عاجز تماماً عن الإجابة عن بعض الأسئلة: أسئلة مثل لماذا إذن حصل ما حصل؟.. لماذا إذن حصل الانهيار إذا كانت التجربة بهذا الكمال؟..
وهو محبط مع التسويديين من باب أولى. إذا كان الجيل الأول (وهو هدف التسويديين الأول) قد تعامل بهذا الشكل، وهو الأقرب لعهد الوحي، فهل يمكن أن ينتج أي تعامل أفضل، بعد قرون متطاولة من عهد الوحي؟
والرؤية الموضوعية، البعيدة عن المطلقين؛ الأبيض والأسود، هي التي تتخلص من هذه النتيجة في الحالتين، وهي الرؤية التي يعاديها السدنة والزبانية أكثر مما يعادون بعضهم بعضاً، فوجود كل منهما أساسي للآخر، أما الرؤية الموضوعية فستنفي الحاجة إلى وجودهم سوية، الرؤية الموضوعية ستفصل التجربة الإنسانية عن النص الإلهي، ولن تتعامل بمفهوم معصومية البشر (وهو مفهوم نظرت له فئة واعتبرته أصلاً من أصولها، بينما تعاملت فئة أخرى معه دون أن تسميه، عبر استبعاد الخطأ واحتماله وإمكانيته من بضعة آلاف من الجيل الأول).. فالجيل الأول، بناة الحضارة، كانوا بشراً، بل إن أعظم ما فيهم أنهم كانوا بشراً، ولذلك فتجربتهم قابلة للاقتداء، وقابلة لأن تكون قد أخطأت هنا أو هناك، و قابلة أيضاً لأن تصحح وتسدد..
الاستثمار في التاريخ، من أجل مستقبل أفضل ممكن.. وسيكون استثماراً رابحاً وإيجابياً.. فقط لو ابتعدنا عن رؤية السدنة ورؤية الزبانية، وعن الأبيض والأسود باعتبارهما اللونين الوحيدين الموجودين في العالم..